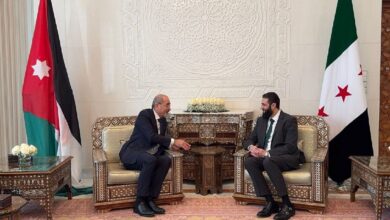بدأ الرئيس ترامب عهده منذ ثلاث سنوات بانتقاد شديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) وأقال مديره بسبب التحقيقات حول الدور الروسي في انتخابات الرئاسة بالعام 2016، ثمّ أقال ترامب وزير العدل جيف سيشن لأنّ الوزير لم يضغط لوقف التحقيقات.
وشهد عهد ترامب حتّى الآن أكثر من ستّين استقالة أو إقالة لأشخاص كانوا يعملون في إدارته أو داخل البيت الأبيض، كان من بينهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس الذي أوضح في رسالة استقالته مدى خلافه مع سياسات ترامب الخارجية، ثمّ مستشاره لشؤون الأمن القومي جون بولتون.
وقد اختلف ترامب أيضا مع وكالة المخابرات الأميركية في تقييمها لعدّة قضايا دولية، كما انتقد البنك المركزي عدّة مرّات بسبب رفع سعر الفائدة.
وربّما من المهمّ أيضاً تذكُّر انتقادات ترامب حينما تولّى الرئاسة لوزارة الخارجية ودعوته لتقليص حجمها، ثمّ لخلافه مع عددٍ من القضاة حول قراره بحظر السفر لأميركا من عدّة دول إسلامية، ولحملاته المستمرّة ضدّ الإعلام الأميركي متّهماً إيّاه بأنه عدوّ الشعب! بل حتّى بعض أركان الحزب الجمهوري الذي يمثّله في الحكم لم يسلموا من انتقادات ترامب وهجومه على كلّ من لا يوافق على أجندته.
إذن، مشاكل ترامب كانت مع معظم المؤسّسات الفاعلة في الحياة الأميركية، وليس فقط مع الحزب الديمقراطي، وهذا يؤكّد بأنّ المشكلة هي في ترامب نفسه وليس في الحزب الديمقراطي المنافس له الآن أو في «الدولة العميقة» التي يشير إليها ترامب في تصريحاته.
ولا نعلم بعد ماذا يخبئ ترامب من مفاجآت في سياسته الخارجية خلال الأشهر القادمة قبل موعد الانتخابات في نوفمبر، حيث هو بحاجة إلى حدثٍ خارجي كبير يُهمّش ما يحصل داخل الولايات المتحدة من محاولات الديمقراطيين لعزله، بعدما نجحوا في السيطرة على مجلس النواب وأقرّوا مشروع قانون عزل الرئيس عن منصبه.
لقد تحدّث ترامب عن «أميركا أوّلاً» بينما ما يمارسه من سياسية خارجية أدّت وتؤدّي إلى عزلة الولايات المتّحدة دولياً حتّى مع حلفاء تاريخيين لأميركا. وهناك أضرار تتحصّل الآن على المصالح الأميركية من جرّاء هذه السياسة «الترامبية» التي لا تأبه إلّا لتعهّدات ترامب في حملته الانتخابية، ووفق معايير شخصية محض، ومراعاةً فقط لمصالح فئوية ترتبط بالرئيس نفسه وبقاعدته الشعبية التي تُهيمن عليها جماعات عنصرية وصهيونية متطرّفة.
إنّ شعار «أميركا أولاً» الذي رفعه ترامب في حملته الانتخابية، وكرّره ويكرّره في أكثر من مناسبة، هو نقيض الواقع والممارسة العملية لسياسة إدارته، حتّى في المجتمع الأميركي نفسه. فشعار «أميركا أوّلاً» يتطلّب على المستوى الداخلي رئيساً يحرص على التعدّد الإثني والعرقي في المجتمع الأميركي، وترامب صرّح وتصرّف عكس ذلك مع الأميركيين الأفارقة والمسلمين والمهاجرين اللاتينيين. والمصلحة القومية الأميركية تفترض وجود رئيس في «البيت الأبيض» يعمل لصالح الفئات الفقيرة والمتوسّطة من الأميركيين، وترامب خدم ويخدم الفئة القليلة من الأثرياء في الكثير من مراسيمه الرئاسية وقوانين الكونغرس «الجمهوري»، وما يتّصل بها من مسائل الصحّة والهجرة والضرائب والضمانات الاجتماعية.
ولقد فشلت إدارة ترامب في تعديل قانون الرعاية الصحية الذي أقرّته إدارة أوباما، وفشلت حتّى الآن في وضع قانونٍ للهجرة وفي بتِّ موضوع المهاجرين غير الشرعيين المولودين في أميركا، لكن إدارة ترامب نجحت في وضع قانونٍ جديد للضرائب وصفه الكثير من المعلّقين بأنّه جاء لصالح الشركات الكبرى والأثرياء وليس لصالح الطبقة الوسطى والفقراء.
وهذا الفشل أو التعثّر لأجندة ترامب على المستوى الداخلي رافقه التحقيقات بشأن دور روسيا في الانتخابات الماضية، ثمّ تحقيقات مجلس النواب عن ضغوطاته على أوكرانيا بشأن أعمال ابن جو بيدن المرشّح الديمقراطي المنافس له في الانتخابات القادمة، إضافةً إلى ما جرى كشفه أيضاً عن فضائح علاقاتٍ جنسية قام بها ترامب قبل وصوله للبيت الأبيض، وتمنّعه عن كشف المعلومات الخاصة بحساباته الضرائبية، وهي قضايا لها تبعات قانونية وسياسية.
الحال هو نفسه على مستوى السياسة الخارجية الأميركية، حيث أخرج ترامب الولايات المتحدة من اتّفاقيات دولية وهدّد بالخروج من المزيد منها، وهي اتّفاقيات تحقّق مصالح قومية أميركية مع جيرانها الكنديين والمكسيكيين ومع الحلفاء الأوروبيين ودول أخرى في آسيا.
فأين «أميركا أولاً» في تزايد مشاعر الغضب لدى شعوب دول العالم تجاه السياسة الأميركية ورمزها في «البيت الأبيض»؟! وأين كانت «المصالح القومية الأميركية» في قرار ترامب بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وبنقل السفارة الأميركية إليها، وهو قرار يتناقض مع قرارت دولية صادرة عن «مجلس الأمن» ومع سياسة أميركية سار عليها كل من سبقه من رؤوساء أميركيين؟!.
ولعلّ ما سبق ذكره يُعزّز المخاوف من أن يُقدِم ترامب على افتعال أزماتٍ دولية، أو ربّما تورّط عسكري في حروبٍ جديدة، لتغطية ما يحدث من تعثّر وفشل داخلي، ولكي تستعيد إدارته بعضاً من الثقة والتأييد وسط الرأي العام الأميركي. وهذا أسلوبٌ مارسته إدارات أميركية مختلفة حينما كانت تتعثّر أجنداتها الداخلية أو حينما تكون في مأزقٍ سياسيٍّ شديد، باعتبار أنّ الأميركيين يقفون مع رئيسهم، ظالماً أو مظلوماً، حينما تخوض واشنطن حروباً خارجية!.
إنّ مصطلح «الدولة العميقة» الذي انتشر استخدامه مؤخّراً للتعبير عن دور «مراكز القوى» في عدّة بلدان، هو ليس بالضرورة توصيف لحال سيء في الولايات المتحدة الأميركية. فالدولة العميقة في أميركا هي الأجهزة الأمنية المختلفة، وهي مؤسّسة وزارة الدفاع، وهي الخبراء في وزارة الخارجية وفي البنك المركزي وفي السلك القضائي، إضافةً طبعاً إلى بعض معاهد الفكر والأبحاث وقوى الضغط داخل مجلسيْ الكونغرس.
ولا تخلو فترة أي رئيس أميركي من مواجهة، ولو محدودة، مع جزء من قوى «الدولة العميقة الأميركية»، لكن ما يحدث مع الرئيس الحالي دونالد ترامب تجاوز الحدود كلّها وشمل معظم مؤسّسات «الدولة العميقة»، وهو أمرٌ يحدث للمرّة الأولى في التاريخ المعاصر للولايات المتحدة.
ترامب يوحي بانتقاداته ضدّ «الدولة العميقة» بأنّ هناك «مؤامرة» على حاكم «البيت الأبيض» من قبل المؤسّسات العميقة في الحكم؟!، بينما الإجابة الأعقل هي بالنفي طبعاً بسبب ما عليه ترامب نفسه من أسلوب في الحكم ومن غيابٍ تام للخبرة في السياسة الخارجية وفي العمل السياسي، ومن فضائح شخصية ومخالفات متّهم بها قبل وصوله للبيت الأبيض، ومن عنجهية ونرجسية في شخصيته تجعل من الصعب التعامل معه حتّى من قبل الأشخاص الذين يختارهم لتولّي المسؤوليات في مؤسّسات الدولة الأميركية.
لقد جرت محاسبة الرئيس السابق بيل كلينتون في حقبة التسعينات والسعي لعزله، فقط لأنه أنكر أولاً علاقته الجنسية مع الطالبة لوينسكي ونتيجة قضية مالية في ولاية أركنسو حينما كان حاكماً لها.
وجرى دفع الرئيس السابق ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة في حقبة السبعينات لأنّه أنكر أولاً معرفته بتجسّس الحزب الجمهوري على مكتب الحزب الديمقراطي في «عمارة واترغيت»، وهي المسألة التي كشفتها صحيفة «الواشنطن بوست»، فكيف يهضم أي عقل الآن بأنّ الرئيس ترامب ما زال يحكم في البيت الأبيض رغم المسائل غير القانونية التي جرى الكشف عنها، والكثير من المخالفات السياسية والمالية والسلوكية التي تورّط بها ترامب طيلة السنوات الماضية؟!.
فالطموحات السياسية للثري ورجل العقارات دونالد ترامب، والتي كانت تتراوح بين منصب حاكمية ولاية نيويورك وبين رئاسة «البيت الأبيض»، عمرها عقود من الزمن، وهي لم تقف على أرضية انتماء فكري أو سياسي لحزب محدّد، بل انطبق على ترامب قول ميكيافيلي: «الغاية تبرّر الوسيلة»، وهذا ما فعله ترامب عقب فوز باراك أوباما بانتخابات العام 2008، حيث لمس حجم ردّة الفعل السلبية التي جرت في أوساط الجماعات المحافظة والعنصرية داخل المجتمع الأميركي، نتيجة فوز أميركي من ذوي البشرة السوداء وابن مهاجر أفريقي مسلم، بأهمّ موقع سياسي في أميركا والتي ما زالت العنصرية متجذّرة في أعماق الكثير من ولاياتها الخمسين.
ففوز ترامب بالانتخابات الرئاسية عام 2016 لم يكن العامل الأساس فيه شخصه، ولا طبعاً مؤهّلاته أو خبراته المعدومة في الحكم والسياسة، بل كان العامل الأساس هو الصراع الدفين الحاصل في المجتمع الأميركي بين المتمسّكين بأميركا الأصولية القديمة، التي قامت على الرجل الأوروبي الأبيض البروتستانتي والعنصري أحياناً، وبين أميركا الحديثة «التقدّمية» التي أصبح أكثر من ثلث عدد سكّانها من المهاجرين من إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، والتي فيها التسامح الديني والثقافي والاجتماعي، والتي أنهت العبودية وأقرّت بالمساواة بين الأميركيين بغضّ النظر عن اللون والدين والعرق والجنس، والتي أوصلت باراك حسين أوباما ابن المهاجر المسلم الإفريقي إلى أعلى منصب في الولايات المتحدة. وقد نجحت قوى «أميركا القديمة» في إيصال ترامب إلى «البيت الأبيض» حتّى على حساب مرشّحين آخرين من «الحزب الجمهوري» بسبب قيام حملته الانتخابية على مفاهيم ومعتقدات هذه القوى الأميركية «الرجعية».
وستكون الانتخابات الأميركية القادمة في شهر نوفمبر حاسمة ومهمّة جداً لتقرير مستقبل أميركا السياسي والأمني والاجتماعي، فالمجتمع الأميركي يشهد الآن درجاتٍ عالية من الانقسام والتحزّب، ولن يكون من السهل إعادة وحدة الأميركيين أو الحفاظ على تنوّعهم الثقافي والإثني في حال جرى تجديد انتخاب ترامب لولايةٍ ثانية.
مدير مركز الحوار العربي في واشنطن
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية