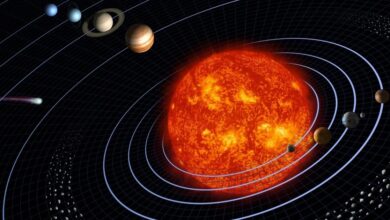لا أحد بوسعه أن ينفي صدق المشاعر العامة تحت صدمة الرحيل المفاجئ للدكتور أحمد زويل، أهم عالم منذ الدكتور «مصطفى مشرفة» أول عميد مصري لكلية العلوم.
ولا أن يسحب باسم أي خلاف سياسي أحقيته في نيل جائزة «نوبل» للكيمياء عن «الفيمتو ثانية»، أحد أبرز الاكتشافات العلمية المعاصرة وأكثرها تأثيراً.
هو «عبقري» في مجاله وكاد يحصل على جائزة «نوبل» ثانية.
قد تتفق أو تختلف مع «زويل السياسي»، وهو رجل أطل على السياسة المصرية عن قرب، تابع أسرارها وكواليسها، حاور اللاعبين الرئيسيين فيها، فتح قنوات اتصال مع مراكز التأثير وصناعة الرأي العام، وفكر لبعض الوقت بعد ثورة «يناير» في الترشح لرئاسة الجمهورية قبل أن يتراجع عن الفكرة كلها، غير أن قيمته العلمية الفريدة لا يصح أن تدخل في أي سجال.
من السخف أن ينسب حصوله على جائزة «نوبل» لأية تزكية.
هذا الكلام يمكن أن يقال عن جائزة «نوبل» للسلام، التي حصل عليها الرئيس الأسبق «أنور السادات» مناصفة مع رئيس الوزراء «الإسرائيلي» في ذلك الوقت «مناحيم بيجن»، وفق حسابات المصالح الغربية.
كان حصول الدكتور محمد البرادعي على الجائزة نفسها مناصفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي كان يترأسها، تعبيراً عن حسابات أخرى فهكذا قواعد اللعبة.
جوائز «نوبل» في الآداب أكثر انضباطاً بمعاييرها دون أن تغيب عنها حسابات السياسة.
وقد حازها «نجيب محفوظ» عن استحقاق لا شك فيه. ف«محفوظ» واحد من ضمن أية قائمة مختصرة لأعظم الروائيين في القرن العشرين، وقد تأخرت الجائزة المستحقة طويلاً قبل أن تصل إليه.
ما يتبقى في النهاية عنوان وحيد على تجربة أحمد زويل بكل إنجازاتها الفريدة وتعرجاتها المثيرة العلم، ولا شيء آخر غير العلم.
بلا بناء جدي لمؤسسات البحث العلمي فلا أمل في أي مستقبل.
يحسب له أنه اجتهد بقدر ما يستطيع في شرح قضية العلم للجمهور العام بلغة بالغة الجاذبية، كإعلامي محترف يعرف كيف يخاطب ويؤثر ويقنع.
اكتسب نجوميته الاستثنائية من قدراته على التواصل، وهو يكاد يكون العالِم العربي الوحيد الذي اكتسب هذه الصفة.
قلت له ذات مرة بعد لقاء تلفزيوني معه كاد يفسده محاوروه لولا مواهبه الطبيعية في التصرف أمام الكاميرات: «لو لم تكن عالماً كبيراً لكنت إعلامياً قديراً».
ثم إنه حاول بأقصى طاقته أن ينتقل من التبشير بالعلم إلى بناء مؤسسي جامعي يحمل اسمه.
رغم القيود البيروقراطية والأزمات المتوالية التي صاحبت مشروعه فإنه حاول أن يصنع شيئاً بينما اكتفى آخرون بالكلام.
باستثناء التجربتين اللامعتين للدكتور مجدي يعقوب في مركز القلب بأسوان والدكتور محمد غنيم في مركز الكلى بالمنصورة لا توجد مبادرات كثيرة ذات قيمة علمية وقدرة على الإلهام.
هناك فارق جوهري بين مبادرات الأفراد وسياسات الدول، فالأولى رغم نبل دوافعها تأتي من خارج السياق العام وتكشف بعض عجزه بينما واجب الثانية أن توفر أوضاعاً مؤسسية تستقطب الكفاءات وتراكم الخبرات في بيئة حاضنة تشجع البحث العلمي وتضمن احتياجاته وأسباب نجاحه في مهامه.
بنص الدستور المصري فإن نسبة تصل إلى (٩٪) من إجمالي الناتج القومي تخصص للصحة والتعليم والبحث العلمي، غير أن ما هو ملزم دستورياً جرى الالتفاف حوله في الموازنة الأخيرة.
وفق بعض التقديرات هناك ٣٠٠ ألف مصري حصلوا على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعات الغربية.
وذلك فيض من الكفاءات والخبرات تحتاجها مصر، غير أن أحداً عاقلاً لا يمكن أن يطلب منهم العودة إلى بلادهم إذا لم تكن مؤسسات الدولة ومراكز البحوث قادرة على الاستيعاب والاستفادة.
ثم إن علماء الداخل، وهم على كفاءة مماثلة، يستشعرون ظلماً لا يحتمل من شبه الاستهتار بقيمة اجتهاداتهم ومن البحث العلمي كله كأنه وظيفة لا لزوم لها.
البيئة الطاردة أقوى من تبشير زويل ب«عصر العلم» والتراجع المفزع للجامعات المصرية طبقاً لأي تصنيف دولي لا يمكن تجاوزه بغير سياسات جديدة تضع التعليم على رأس كل الأولويات.
بحسب شهادة زويل نفسه فقد حصل على تعليم متقدم في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية نهايات الستينات أفضل مما كان يحصل عليه نظراؤه في الولايات المتحدة الأمريكية.
الشهادة بنصها استمعت إليها قبل نحو عشر سنوات من مجموعة مهندسين حصلوا على درجة الدكتوراه من الجامعات الكندية بينهم الدكتور محمد شاكر أفضل مهندس استشاري مصري بالكهرباء قبل أن يصبح وزيراً.
لماذا تدهورنا إلى هذا الحد؟
هذا سؤال رئيسي قبل أي حوار في إصلاح التعليم.
لم تكن أزمته في مجانيته، بل على العكس فإن المجانية أتاحت ل«زويل» ابن الطبقة الوسطى الصغيرة التقدم إلى ما وصل إليه من منزلة دولية حتى بات مستشاراً علمياً لرئيس الولايات المتحدة.
39 3 دقائق